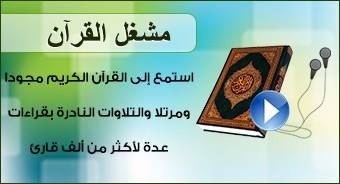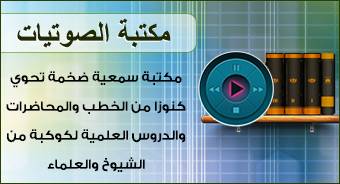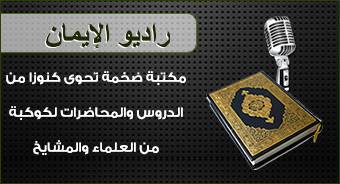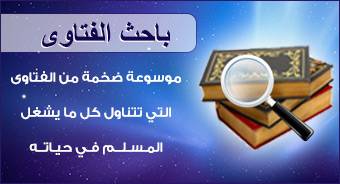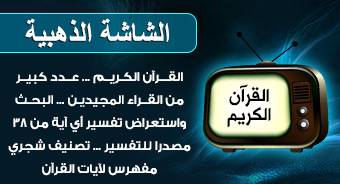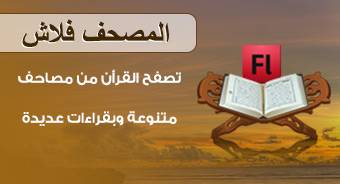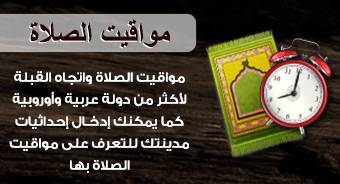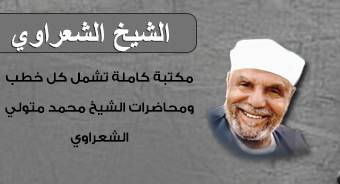|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وقال في (النهاية): وسط العضد، وقيل: (ما تحت الإبط): جنس من السباع من الفصيلة الضبعية ورتبة اللواحم، أكبر من الكلب وأقوى، وهي كبيرة الرأس قوية الفكين، وهي مؤنثة، وقد تذكّر، قال المطرزي: وهي أخبث السباع. [مشارق الأنوار 2/ 55، والنهاية 3/ 73، والمغرب ص 279، والمعجم الوسيط 1/ 554].
[مشارق الأنوار 2/ 55، والمصباح المنير (ضج) ص 135].
ويقولون: (جاء فلان بالضّح والريح) يراد به الكثرة: أي ما طلعت عليه الشمس وما جرت عليه الريح، والضحضاح: الماء إلى الكعبين. [معجم المقاييس ص 598، والمعجم الوسيط 1/ 555].
وبالقصر: من أول ارتفاعها. قيل: المقصور: حين تطلع الشمس، والممدود: إذا ارتفعت. [المشارق 2/ 56، ومقدمة فتح الباري ص 155].
قال ابن فارس: هو دليل الانكشاف والبروز، وهو انبساط الوجه وبدو الأسنان من السرور. وضحك السحاب: انجلى عن البرق. قال الشاعر: وكقولهم: (ضحكت الأرض): إذا أخرجت نباتها وزهرتها. قال ابن مطير: وقال الأعشى: فائدة: 1- الضواحك أربعة، وسميت ضواحك، لأنها تظهر عند الضحك، ويقال لواحدها: ضاحك بغير هاء، وأكثر أهل اللغة على تذكيره، وذكر ابن فارس: ضاحكة. 2- قال أبو زيد: للإنسان أربع ثنايا، وأربع رباعيات وأربعة أنياب، وأربعة ضواحك، واثنتا عشرة رحا، ثلاث في كل شق، وأربعة نواجذ، وهي أقصاها. [معجم المقاييس ص 613، 614، وغريب الحديث للخطابي 1/ 466، 671، والمصباح المنير ص 136].
وذكر أبو البقاء: أن الضد معناه: العون ويكون جمعا. قال الله تعالى: {وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} [سورة مريم: الآية 82]، فإن عون الرجل يضاد عدوه وينافيه بإعانته عليه. واصطلاحا: قال الشيخ زكريا: أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد. قال الفيومي: والمتضادان: اللذان لا يجتمعان كالليل والنهار. وزاد أبو البقاء: من جهة واحدة، قال: وقد يكونا وجوديين كما في السواد والبياض، وقد يكون أحدهما سلبا وعدما كما في الوجود والعدم. قال: والضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان كالسواد والبياض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون. [المصباح المنير ص 136، والمعجم الوسيط 1/ 556، والحدود الأنيقة ص 73، والكليات ص 574، 575].
- وقال الأزهري: كل ما كان سوء حال، وفقر وشدة في بدن، فهو: ضر بالضم، وما كان ضد النفع، فهو بفتحها. وفي التنزيل: {مَسَّنِيَ الضُّرُّ} [سورة الأنبياء: الآية 83]: أي المرض، وقد أطلق على نقص يدخل على الأعيان. ورجل ضرير: به ضرر من ذهاب بصر أو ضنى، وضاره مضارة، وضرارا، بمعنى: ضره وضرّه إلى كذا، واضطره، بمعنى: ألجأ إليه وليس منه بد. [المفردات ص 287، والمصباح المنير ص 136، والمعجم الوسيط 1/ 558].
[النهاية 3/ 83، والمطلع ص 340].
ضرس، وهو مذكر، وقد يؤنث على معنى (السنّ). [المعجم الوسيط (ضرس) 1/ 558 (معجم)، والمغرب ص 282].
والضروري: كل ما تمس إليه الحاجة، مما ليس منه بد، والجمع: الضروريات. وهي عند الأصوليين: الأمور التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال. [المصباح المنير ص 138، والمعجم الوسيط 1/ 558، والموافقات 2/ 8، والمستصفى 1/ 287].
[المغرب ص 282، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 657].
والضّغث- بالفتح-: الخلط، ومنه قوله تعالى: {قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ} [سورة يوسف: الآية 44]. [غرر المقالة ص 99، والمعجم الوسيط 1/ 561، والمغرب ص 283].
وفي اصطلاح الفقهاء: الضغطة: أن يلجئ غريمه ويضيق عليه. - وقيل: هو أن يقول: لا أعطيك أو تدع من مالك على شيئا. - وقيل: هي أن يكون للرجل على الرجل دراهم فجحده فصالحه على بعض ماله، ثمَّ وجد البينة فأخذه بجميع المال بعد الصلح. المضغوط: - قيل: من أضغط في بيع ربعة أو شيء بعينه أو في مال يؤخذ منه ظلما، فباع لذلك. - وقيل: من أكره على دفع المال ظلما فباع لذلك. [المصباح المنير ص 137، والمعجم الوسيط 1/ 561، والمغرب ص 283، 284].
والضّفف- بفتحتين-: العجلة في الأمر. وأيضا: كثرة الأيدي على الطعام. [المصباح المنير ص 137، 138].
وحكى المطرز في (شرحه): ضفدع بضم الضاد وفتح الدال ولم أر أحدا حكى ضمها. وهو حيوان بر مائي ذو نقيق، يقال للذكر والأنثى، والجمع: ضفادع، يقال: (نفثت ضفادع بطنه): إذا جاع. [المطلع ص 382، والمعجم الوسيط 1/ 561، 562].
والضفيرة: كل خصلة من الشعر تضفر على حدة. وضفيرة الحائط: يبنى في وجه الماء، والجمع: ضفائر وضفر. [المصباح المنير (ضفر) ص 137، والمعجم الوسيط 1/ 562].
والضلال: أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقا أصلا. العدول عن الطريق المستقيم. والضلالة، بمعنى: الإضاعة، كقوله تعالى: {فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ} [سورة محمد: الآية 4]. وبمعنى: الهلاك كقوله تعالى: {وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ} [سورة السجدة: الآية 10]. فالضلالة أعم من الضلال. - قال الجرجاني: الضلالة: فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وقيل: هي سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب. [المعجم الوسيط 1/ 563، والمصباح المنير ص 138، والكليات ص 576، والتعريفات ص 121، والمغرب ص 284].
والضلع: مؤنثة، والضلع: الميل، ومن هذا قولك: (ضلعك مع فلان): أي صفوك وميلك إليه. - قال النابغة: [غريب الحديث للخطابي 1/ 397، والمغرب ص 284، والمطلع ص 367، والمصباح المنير ص 138، والمعجم الوسيط 1/ 563].
عصبه وشدّه بالضماد، والضمد: أن تتخذ المرأة صديقين، ذكره ابن فارس. [معجم مقاييس اللغة (ضمد) ص 602، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 537].
قال الجوهري: الضمار: ما لا يرجى من الدين والوعد، كل ما لا تكون منه على ثقة، كذلك يطلق الضمار في اللغة: على خلاف العيان، وعلى: النسيئة أيضا، وقيل: أصل الضمار ما حبس عن صاحبه ظلما بغير حق. وحكى المطرزي: أن أصله من الإضمار، وهو التغيب والاختفاء، ومنه: أضمر في قلبه شيئا. أما الضمار من المال: فهو الغائب الذي لا يرجى عوده، فإذا رجى فليس بضمار. [المغرب ص 284، 285، والموسوعة الفقهية 28/ 213، والمعجم الوسيط 1/ 564، والمصباح المنير ص 138]. |